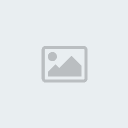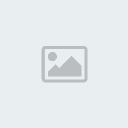عشرة أدلة على حجية السنة
الحمد لله الذي أمر باتباعه نبيه الأمين، والصلاة والسلام على المطاع سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه نقلة الشرائع والدين، وعلى تابعيه بالسمع والطاعة، حشرنا الله في وفدهم، آمين.
وبعد، فمما تواتر في الأخبار، ونص عليه الأئمة الأخيار، واقتضته عادة الناس، وتواتر عند العام والخاص، وأوجبه العقل صحيحاً، ودل عليه القرآن صريحاً: حجية السنة النبوية المطهرة، على صاحبها والمتمسك بها أفضل الصلاة والسلام.
وإني لو أقسمت بالله أن الأدلة على ذلك أكثر من ألف ما كنت حانثاً إن شاء الله تعالى. لكن لما كنت قد تعهدت أن ألتزم بالاكتفاء بعشر أدلة، فإني موفّ غير ناقض عهداً. قال تعالى: (قد أفلحَ المؤمنونَ ) ثم ذكر من أوصافهم: (وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ).
فإلى المقصد، والله أسأل أن يوفق ويسدد، ويهدي به إلى الحق ويرشد.
وجوه الدلالة من الآية الكريمة:
ربنا سبحانه وتعالى قال: ( وأطيعوا الله ) ثم قال: ( وأطيعوا الرسول ). فهنا أثبت طاعتين ومطاعين. بمعنى أن الفعل الأول مضارع كما لا يخفى، والمضارع يتضمن مصدراً، فالمعنى: ( وأطيعوا الله تعالى طاعةً، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة ). ومعلوم أن الأصل إن تعاقب نكرتان أن ذلك يدل على تغايرهما. مثال ذلك قوله تعالى: ( إن مع العسر يسراً. إن مع العسر يسراً ) أي مع العسر يسران، يسر بأجر الصبر، ويسر بالفرج. على كلٍّ، يكون المعنى هنا: ( وأطيعوا الله تعالى طاعةً، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم طاعةً أخرى ).
فإذا ثبت هذا التغاير، قلنا: ما الطاعة التي لله، وما الطاعة المغايرة التي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالجواب: أن طاعة الله هي طاعة ما بلغنا من كلامه، وهو القرآن، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي طاعة ما بلغنا من كلامه كذلك، وهي السنة النبوية.
لو كان مراد الله تعالى في هذه الآية الكريمة: ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما يبلغكم من القرآن )، لو كان ذاك هو المعنى لكان اللازم فصاحةً وبلاغةً أن تضمر الطاعة الثانية، إذ هي عين الأولى.
لم يجب ذلك؟ لأن الأفضل في كلام العرب قصر الكلام، ولا يؤتى بالتطويل إلا لفائدة زائدة. فكيف إن كان في التطويل إيهام بخلاف المقصود؟! لا شك يكون الإضمار آكد وآكد.
لو كان المراد هنا بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة ما جاء به من القرآن، لاستوى بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع غيره من آحاد البشر، بل لاستوى مع الكفرة والشياطين. كيف؟ معلوم أن طاعة كلام أي أحد يأمر بما في القرآن لازمة لا محيد عنها، فلو قال لك مثلاً: صم رمضان، للزم أنك تصومه، لا طاعة لذاته، لكن لموافقة القرآن. ومعلوم بالضرورة أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مزية زائدة على غيره، فما هي هذه المزية إلا أن تكون طاعته في شيء زائد على ما في القرآن؟! وهذه هي السنة. والحمد لله رب العالمين.
أن الله تعالى هنا علق طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كونه ( الرسول ). وبالتالي فله من الطاعة ما يكون للرسول على قومه. فنرى في القرآن الكريم كثيراً أن الله تعالى يلزم الكافرين طاعة رسلهم في أمور غير التي في كتبهم. وذلك أشهر من أن يذكر، لكن أمثل له بمثالين واضحين.الأول قوله تعالى: ( فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ). فهنا جعل الله تعالى وحيه إلى نبيه إبراهيم أمراً، مع كونه مناماً ليس في كتاب. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمره الله ويأمر أمته بوحي ليس بقرآن. إذ ليس رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ببدع من الرسل، قال تعالى: ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ).
الثاني قوله تعالى: ( ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى ).
فهنا وحي من الله تعالى إلى موسى فيه تكليف له ولقومه بالإسراء، وليس هو من التوراة، إذ التوراة نزلت بعد هذا عندما لقي موسى ربه. وكذلك يجوز لنبينا ما يجوز لموسى عليهما الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
ووجه دلالة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل زمن إلى قيام الساعة قوله تعالى قبل هذه الآية في نفس سياقها: ( يا أيها الذين آمنوا ). ووجه آخر أن قوله تعالى: ( وأطيعوا ) فيه ضمير الرفع المتصل، وهو مفيد للعموم.
أن الله تعالى أمر بأخذ الذي آتانا الرسول وترك ما نهانا عنه، والأمر يفيد الوجوب. وما آتى الرسول وما نهى عنه هو السنة النبوية، وبالتالي فهي واجبة الاتباع. ويؤكد هذا المعنى تتمة الآية: ( واتقوا الله إن الله شديد العقاب ).
هنا أسند الله تعالى الإتيان والنهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أنهما صادران منه. ولو كان المراد ما آتى القرآن ونهى، لما صح أن يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ القرآن كلام الله تعالى، وليس كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام يسند إلى من صدر منه أولاً لا إلى ناقله ومن تكلم به بعد ذلك. فلا يقال عن القرآن أنه كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بلغه، بل هو كلام الله تعالى لأنه هو من ابتدأ التكلم به. وتأمل رد الله تعالى على المشرك القائل عن القرآن: ( إن هذا إلا قول البشر ) قال: ( سأصليه سقر ).
سياق الآية في معرض الحديث عن قسمة الفيء، قال تعالى: ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ). ومعلوم عقلاً واضطراراً أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
كما في قوله تعالى: ( قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ). فكون الله لا يضيع أجر المحسنين عامٌّ لفظاً، وإن كان في سياق الحديث عن رجلين خاصين، هما يوسف وشقيقه، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
العلة في وجوب إطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أنه مبلغ عن ربه، ولذلك وصف هنا بالرسالة، إشارة إلى أن الذي يبلغه عن ربه وليس من عند نفسه. وهذه العلة كما هي موجودة في قسمة الغنائم، فهي موجودة في كل أمر ونهي صادرٍ منه صلى الله عليه وآله وسلم.
ودليل عموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل من بلغته هو الضمير المتصل في قوله تعالى: ( فخذوه ) وفي قوله: ( فانتهوا ) لأنه يفيد العموم.
هنا علق الله تعالى طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كونه رسولاً، فقال: ( وما آتاكم الرسول ) فدل على أن له من الطاعة ما يكون للرسول على قومه. وقد ثبت - كما مر - أن للرسول على قومه طاعة زائدة على مجرد ما في كتابه. والحمد لله رب العالمين.
ووجوه الدلالة من الآية كما يلي:
أن الله تعالى حرم مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ورتب على مشاقته ألواناً من أشد العذاب. ففي الدنيا يوليه الله تعالى شيطانه الذي آثر اتباعه على طاعة النبي ليزداد إثماً وضلالاً. قال تعالى: ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ). وفي الآخرة يصليه الله تعالى جهنم ويحرمه الجنة، كما استبدل في الدنيا طاعة النبي بطاعة الشيطان.
أن الله تعالى هنا حرم مشاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الآية الأخرى حرم مشاقته نفسه سبحانه وتعالى، فقال: ( ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ). فلو كان المراد بمشاقة الرسول مشاقته فيما جاء به من القرآن، لاستوت الآيتان ولم يكن ثمة حكمة من التفريق بينهما.
وتأمل كذلك قوله تعالى: ( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ). فلو كانت مشاقة الرسول هي مشاقته فيما جاء به من القرآن، لما كان فائدة من ذكره، ولكان القول: ( ذلك بأنهم شاقوا الله ). لكن لما كانوا قد شاقوا القرآن الذي هو كلام الله والسنة التي هي كلام الرسول، حسن النص عليهما كليهما.
أن تحريم مشاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي تحريم مخالفته في كل أمر أو نهي صدر منه، سواء كان من القرآن أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ). وظاهر أن ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أمسك ) ليس من القرآن، بل قد نزل القرآن بعده.
ويدل لذلك أيضاً أن المشاقة التي حرمها الله تعالى هنا مطلقة، غير مقيدة بما جاء في القرآن ولا بما وافقه ولا بغير ذلك، فوجب أن تحمل على إطلاقها. ومن قيد ما أطلق الله تعالى فقد شاقه، والله المستعان.
أن الله تعالى علق تحريم مشاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا على كونه رسولاً، فقال: ( ومن يشاقق الرسول ). وبالتالي فإن له صلى الله عليه وآله وسلم من الطاعة ما يكون للرسول على قومه. وقد ثبت - كما مر - أن للرسول على قومه طاعة زائدة على مجرد ما في كتابه، وهي السنة. فالحمد لله رب العالمين.
دليل عموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآية الاسم الموصول ( من ) إذ أنه يفيد العموم.
والآية هنا ذكر لما حدث في غزوة أحد، إذ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرماة من أصحابه أن يلزموا الجبل وألا ينزلوا عنه لجمع الغنائم، ولو رأوا ظفر المسلمين. ثم لما ظهر المسلمون على الكفار، اختلف الرماة، فمنهم من سبق إلى الغنائم وعصى، ومنهم من ثبت وقتل. وقد عفا الله عمن أخطأ منهم فقال: ( ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ).
وجوه الدلالة من الآية الكريمة كما يلي:
أن الله تعالى أثبت أمراً لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الأمر غير موجود في القرآن قطعاً. ثم أثبت أن من خالف هذا الأمر كان عاصياً آثماً، فدل على وجوب اتباع ذلك الأمر. فهذا دليل على وجود سنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى وجوب اتباع تلكم السنة.
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر وينهى بأوامر ونواهي زائدة على ما في القرآن الكريم. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله ). وقوله تعالى: ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ). وقوله تعالى: ( ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ). وكما قال تعالى: ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) فدل على أن النبي أمرهم بالقتال والغزو ثم هم تخلفوا، ومعلوم أنه ليس في القرآن أمر بغزوة بعينها ولا بمكانها ولا بزمانها، وإنما كان ذلك بوحي غير قرآن، وهو السنة النبوية المطهرة.
أن العلة في الهزيمة هنا هي عصيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الآية الكريمة. وهذا نوع عقوبة، فدل على تحريم ذلك العصيان ووجوب ضده وهي الطاعة. ثم هذه العلة متعدية كما لا يخفى، وبالتالي فالعبرة بتعديها لا بخصوص السبب، فيحرم كل عصيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أن الله تعالى قال بعد هذه الآية: ( إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ). فعلق الله تعالى الأحكام الواردة في الآية على وصف ( الرسول ) وليس مجرد القائد، فدل على أن علة تحريم عصيانه كونه رسولاً، وليس لمجرد أنه قائد المعركة.
ثم تعليقه سبحانه الوصف بالرسالة دليل على أن له صلى الله عليه وآله وسلم من الطاعة ما يكون للرسول على قومه. وقد مر سابقاً أن للرسول طاعة زائدة على ما في كتابه، وهي السنة. والحمد لله رب العالمين.
وجوه الدلالة من الآيتين الكريمتين كما يلي:
أن الله تعالى قرر أنه أرسل مع كل نبي قبل نبينا صلى الله عليهم وسلم أمران، الأول البينات والثاني الزبر وهي الكتب. فدل على أنهم أرسلوا بشيء زائد على ما في الكتب، وهي البينات.
ثم البينات جمع بينة، وهي فعيل إما بمعنى فاعل أو مفعول، فعلى الأول بينة بمعنى بائنة أي واضحة، وعلى الثاني بينة بمعنى مبيَّنة أي موضَّحة. والواضحات هي آيات الأنبياء ومعجزاتهم، لوضوح دلالتها على صدقهم، والموضَّحات هي سننهم وشرائعهم فصلت لهم، والله أعلم.
وعلى المعنى الأول قوله تعالى: ( سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ) وعلى الثاني قوله تعالى: ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينةُ رسولٌ من الله ).
وحيث أن اللفظ هنا مشترك ولا مرجح لأحد المعنيين ولا تنافي بينهما، وجب حمله عليهما جميعاً، إذ تخصيصه في أحدهما من غير دليل تحكم.
ثم لو أردنا قرينة ترجح أحد المعنيين، لكان معنى الشرائع والسنن أولى، لأن الآيتين في مقام الحديث عن الوحي، ولأن الذي ذكر في الآية الثانية لا يحتمل معنى الدلائل والمعجزات.
فإذا ثبت بذلك أنه كان لكل نبي ممن كان قبل نبينا صلى الله عليهم أجمعين سنة زائدة على ما في كتبهم، ثبت أن لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كذلك سنة زائدة على ما في كتابه. إذ ليس رسولنا ببدع من الرسل كما أمره تعالى أن يقول: ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ).
قوله تعالى: ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ). يلحظ فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل الله إليه أمران، الأول القرآن الذي نزل للناس، والثاني بيان يوضح ما في القرآن. ومعلوم أن الموضِّح غير الموضَّح. فدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل إليه شيء زائد على ما في القرآن، وليس ذلك إلا السنة المطهرة.
ثم تأمل أيها القارئ الكريم أنه يمتنع حمل الآية على معنى: ( وأنزلنا إليك القرآن لتبين للناس القرآن ) ليكون القرآن بياناً للقرآن. وهذا الامتناع لأمور:
ان المبيَّن في هذه الآية الكريمة وصفه الله تعالى بأنه ( نُزِّل ) ولم يصفه بأنه ( أُنْزِل ). والفرق بينهما أن ما نُزِّل أي جملة واحدة، وما أنزل أي مفرقاً منجماً أو جملة واحدة.
ومن ذلك قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزّل على رسوله والكتاب – أي الكتب - الذي أنزل من قبل ) فوصف القرآن بأنه منزّل لنزوله جملة واحدة، ووصف الكتب بأنها أنزلت لأنها نزلت مفرقة كل نبي بكتاب. ومثل هذا كثير في القرآن.
فإن ثبت أن المنزل هو كل القرآن، لزم أن يكون الموضح ليس بقرآن، لأن المطلوب بيان كل القرآن، فلو شرح بعضه بعضاً منه، لزم وجود شرح للبعض الشارح، وهكذا إلى أن يحصل التسلسل. فعلم أن السنة النبوية هي الشارحة لكل القرآن.
أن الله تعالى أضاف التبيين المطلوب للقرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ( لتبين ) ولم يقل ( لأبين ) أو ( لنبين ) ومعلوم أن الأصل إضافة الكلام إلى قائله المباشر، فدل على أن البيان صادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والقرآن الكريم لا يصح أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، كما قال تعالى حاكياً قول المشركين: ( إن هذا إلا قول البشر ) فرد عليه بقوله تعالى: ( سأصليه سقر ).
أن الأمرين النازلين من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم موصوفان بوصفين مختلفين في سياق واحد. الأول منزَل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثاني منزَّل إلى الناس كافة. فدل على أن أحدهما أكثر اختصاصاً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآخر.
أما القرآن الكريم فليس بعضه أكثر اختصاصاً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أنه ليس هو الموضِّح المقصود هنا، فبطل أن يكون هو الموضَّح والموضِّح. وإنما الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من اختصاصه بغيره هو السنة النبوية المطهرة. فالحمد لله رب العالمين.
وجه الاستدلال من الآية كما يلي:
أن الله تعالى جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعة له، ورتب على من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد. وهذا يدل صراحة على وجوب الائتمار بأمره صلى الله عليه وآله وسلم فعلاً وتركاً. وهو المطلوب ولله الحمد.
أن الله تعالى هنا علق المدح على طاعة الرسول. فالطاعة هنا قيدت بمطاع هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني أن المطاع فيه صدر منه لا من غيره. إذ لو كانت صادرة عن غيره وكان هو المبلغ لما كان هو المطاع، ولكان المطاع هو المبلغ عنه، إذ الأصل في إضافة الطاعة إلى مطاع أن يكون هو المباشر للأمر والنهي.
أن الآية لم تخص أمراً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون أمر، ولا نهياً دون نهي، وإنما هي عامة في كل من أطاع الرسول في أمٍه أمر به أو في نهي نهى عنه. بيان العموم هو كلمة ( من ) الشرطية، إذ هي من صيغ العموم. وعليه فلا تخصص الآية بمن أطاع القرآن الذي جاء به، ولا تخصص بما كان مسكوتاً عنه في القرآن، بل تعم كل ما صدر منه، سواء كان مخصصاً أو مقيداً أو مبيناً أو زائداً أو ناسخاً لكتاب الله، ولا فرق. ومن فرق فقد خالف الآية.
أن الله تعالى علق المدح على من ( يطيع ) رسوله. والفعل المضارع يفيد التجدد والحدوث. فيكون ذلك دليلاً على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي زمان. فكما أن الآية تتناول أهل كل زمان بعموم لفظ ( من ) الشرطية، فهي كذلك تتناوله بفعل ( يطيع ) المضارع.
وفي هذا الفعل المضارع كذلك تأكيد على المعنى الذي ذكرته في الوجه الثاني، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الآمر المباشر، وليس هو مبلغ، بمعنى أن الكلام الذي فيه الأمر صدر منه هو ابتداء، وإن كان معناه وحي من الله تعالى إليه. وجه التأكيد أن الله تعالى علق المدح على المطيع متى كان زمانه. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيموت، وأن من جاء بعده سيطيعه لينال من الأجر مثل ما نال الصحابي، علمنا أن الطاعة لم تكن لناقل الحديث كالبخاري ومسلم، وإنما بقيت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن الطاعة إنما هي لمن صدر منه الكلام الآمر أو الناهي وليس للناقل. وهذا قوي محكم لا مجال لرده.
أن الله تعالى علق الطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على وصف له، وهو الرسول. فدل على أمرين:
الأول : أن له صلى الله عليه وآله وسلم من الطاعة ما يكون للرسول، وقد تبين مراراً مما سبق أنه قد كان للرسل على أقوامهم من الطاعة أكثر مما فيه كتبهم، فكذلك يكون لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
الثاني : أن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رسول، وليس لأنه مجرد مبلغ، فتكون الحجة في كل قوله قرآناً أو سنةً، وليس كغيره من العلماء والدعاة المبلغين الذين الحجة في الذي يسندون إلى الله والرسول من قولهم لا في كل قولهم.
لو كان المراد أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله لأن قول الرسول لا يخرج عن أن يكون أمراً بما في القرآن، لكان المعنى فاسداً. لأن كل من أمر بما في القرآن كان طاعته في ذلك واجبة، ولا مزية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم ضرورة أن له مزية ليست لغيره.
فإن قيل: المزية أن قوله لا يخرج عن القرآن، بخلاف غيره فيأمر بالقرآن تارة ويخالف تارة. قلنا: وهذا كذلك محجوج، إذ يلزم عليه أن ميزة الرسول هي مجرد العدالة، وهي حاصلة لغيره، فليس مزية له. كما يرده ما مر من الأدلة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بغير ما في كتاب الله تعالى.
أوجه الدلالة منه كما يلي:
أن الله تعالى أثتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمراً. والأمر كلام، والكلام لفظ ومعنى. فالأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظاً ومعنىً هو السنة. ثم الأصل إضافة الكلام إلى الصادر منه ابتداء لا إلى ناقله كما مر غير مرة. ثم حذر الله تعالى عن مخالفة هذا الأمر، فدل على وجوب اتباعه، والحمد لله رب العالمين.
لو كان المراد بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمره بما في القرآن، لما كان له على غيره مزية، والضرورة حاصلة على أن له مزية ليست لغيره، ولا يصح أن تكون أنه لا يأمر إلا بما في القرآن كما مر سابقاً. فلزم أن تكون مزيته وجوب اتباعه فيما أمر به ابتداءً. والحمد لله رب العالمين.
أن هذه الآية جاءت تابعة للآية السابقة لها، وهي قوله تعالى: ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فائذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ). ويتضح منها أمور:
الأول : أن الله أثبت وجوب اتباع أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المباشر المغاير للقرآن، فإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن المعين ليس بقرآن قطعاً، وإنما يكون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتداءً، فدل على أن له علينا أن يطاع فيما أمر به ابتداءً.
الثاني : أن الله سمى هذا الإذن وعدمه في الآية الثانية ( أمراً ) وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أنه صادر منه ابتداءً، وليس هو اتباع لما في القرآن.
الثالث : أن الله تعالى أثنى على مؤمنين استأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل نزول الآية الكريمة، فدل على أن طاعتهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الاستئذان كانت محمودة قبل نزول القرآن بما فعلوا. فدل ذلك قطعاً على أن اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم محمود مطلوب.
الرابع : أن الله تعالى ذم أناساً لم يستأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل نزول الآية الكريمة، بل نفى عنهم الإيمان. فدل ذلك على أن مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت مذمومة قبل نزول القرآن بما فعلوا. فدل ذلك قطعاً على أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمود وأن تركها مذموم.
أن الضمير في قوله ( أمره ) عائد على لفظ ( رسول ). وتعليق الحكم على وصف الرسول، يدل على أن له صلى الله عليه وآله وسلم من الطاعة ما يكون للرسول من رسل الله تعالى. وقد مر سابقاً أنه كان للرسل على أقوامهم من الطاعة أكثر من مجرد ما في كتبهم. والحمد لله رب العالمين.
قوله تعالى: ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ) في صدر الآية يدل كذلك على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذ الإيمان هو التصديق المقرون بالعمل، وليس مجرد التصديق.
دليل ذلك قوله تعالى: ( فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم ) فجعل تصديق الرؤيا تطبيق ما فيها من أمر، ولو كان مجرد اعتقاد وجوبها تصديقاً، لكان مصدقاً من قبل أن يمسك ابنه، ولو كان لترتب عليه ما رتب الله على الإيمان من الفداء، ولو كان لما تل ابنه أصلاً. ويدل على ذلك كذلك قوله تعالى: ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) فسمى الصلاة إيماناً، وهي عمل. وكذلك قوله تعالى: ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) فحصر الإيمان فيهم، فدل على اختصاصه بهم دون من اعتقد من غير عمل. وغير ذلك كثير.
فإذا تقرر ذلك انتقلنا إلى المرحلة الثانية، وهي: قد حصر الله تعالى في آيتنا هنا الإيمان في الذين آمنوا بالله ورسوله، أما الإيمان بالله تعالى فيترتب عليه عمل، وهو اتباع ما تكلم به الله تعالى من القرآن الكريم، ثم الإيمان بالرسول أي عمل يترتب عليه؟ إن قيل نصرته ومحبته، قلنا: هذا مأمور به في القرآن، فهو من الإيمان بالله تعالى. فلما لزم أن يكون للإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقتضىً يعمل به، ولم نجد شيئاً سوى اتباعه، لزم أن يكون الإيمان المطلوب هو اتباعه، واتباعه ليس اتباع ما جاء به من القرآن، فإن هذا إيمان بالله كما مر، وإنما يكون اتباعه باتباع ما اختص به من سنة مطهرة. والحمد لله رب العالمين.
وجوه الدلالة من الآية الكريمة:
أن الله تعالى أثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباعاً واجباً، حيث علق عليه صدق محبة العبد لربه، وهي واجبة، وما تعلق عليه الواجب فهو واجب.
الاتباع هنا مضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل أن يضاف الاتباع إلى المتبوع المباشر. فلا يقال لي إن أمرني رجل بالصلاة فصليت أني قد اتبعته، وإنما يقال أني اتبعت الله تعالى الذي هو الآمر المباشر بالصلاة، وليس ذلك الرجل إلا مبلغاً. وهذا مر كثيراً فيما سبق. فلله الحمد والمنة.
الاتباع المأمور به هنا مطلق، لم يقيد بشيء ألبتة، ولا يصح تقييد ما أطلقه الله سبحانه. فمن زعم أن الاتباع هنا مقيد باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن فقط، فقد خالف القرآن الذي صرح بالعكس.
أن الله تعالى أتبع بهذه الآية الكريمة ما يوضح المراد من الاتباع المذكور هنا، فقال تعالى: ( قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ). فأمر بطاعته سبحانه وطاعة رسوله، ووحد الطاعة هنا لأن طاعة الرسول طاعة لله تعالى الذي قال: ( من أطاع الرسول فقد أطاع الله ). ثم بين سبحانه وتعالى أن من لم يلتزم طاعة الله ورسوله ( بمعنى لم يعتقد وجوبها أو لم يقبل بها ) أنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، والعياذ بالله تعالى.
وجوه الدلالة من الآية الكريمة كما يلي:
أن الله تعالى أثبت طاعة لازمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل أن تضاف الطاعة إلى من صدر منه الكلام أولاً، لا إلى المبلغ. ومثل هذا مر كثيراً ولله الحمد.
لو كان المراد طاعة الرسول بما جاء به من قرآن فقط، ما كان له مزية عن غيره، والاتفاق واقع على أن له مزية ليست لغيره، ضرورة أنه ذكر ولم يذكر غيره من المبلغين كجبريل ونقلة القرآن والعلماء.
فإن قيل: المزية أنه لا يأمر إلا بالقرآن. قلنا: المزية هنا أنه عدل لا يأمر بما يخالف القرآن، وهذا خلاف الاتفاق، لأن العدالة لا تختص به صلى الله عليه وآله وسلم. فلزم أن مزيته صلى الله عليه وآله وسلم وجوب اتباعه. ثم قد تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم تواتراً قطعياً لا يمكن دفعه، أنه كان يأمر بما لم يأت في القرآن، بل ويأمر بما يخالف القرآن ظاهراً ( لكنه مبين في واقع الأمر ) كتخصيص العام وتقييد المطلق.
أن الله تعالى أطلق الطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقيدها بما جاء في القرآن فقط، ولا يجوز تقييد ما أطلق الله تعالى. فدل على أن له علينا من الطاعة أن نطيعه في كل أمره قرآناً كان أو غير قرآن.
أن الله تعالى علق الهداية على هذه الطاعة، فدل على وجوبها. إذ طريق الهداية واحد، ويلزم من تركه أنه غير مهتد كما قال تعالى: ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) فوحد سبيل الهداية وجمع سبل الضلالة. فالحمد لله رب العالمين.
قوله تعالى: ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) يدل على أنه ليس على الرسول أن يتكلم من تلقاء نفسه، ولا أن يشرع هو صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما عليه يبلغ ما يوحى إليه من ربه. وبالتالي يفهم منه أن الأصل في ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وآله أنه وحي وأنه حجة، سواء كان في القرآن أو لم يكن في القرآن.
ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) وقوله تعالى: ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ). فالحمد لله رب العالمين.
ولقارئ أن يستغرب استشهادي بهذه الآية الكريمة، مع وجود عشرات غيرها أوضح منها في الدلالة.
فأجيبه أني أرمي بهذه الآية الكريمة إلى الاستدلال على المطلوب أولاً، ثم الاستدلال على استحالة تفسير القرآن وفهمه من غير السنة ثانياً. وذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى:
أولاً: الأمر هنا مجرد عن القرينة، فيفيد الوجوب كما هو متقرر في علوم العربية.
ثانياً: الأمر هنا مخاطب به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقصود به كل الأمة، كما هو ظاهر من السياق، حيث قال تعالى: ( قم فأنذر. وثيابك فطهر. والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر. ولربك فاصبر ). وهذا هو الأصل في خطاب الله تعالى لنبيه أن يراد به الأمة كلها إلا بدليل على التخصيص، كما في قوله تعالى: ( يا أيها النبي اتق الله ) وقوله تعالى: ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ) وغيرها.
ثالثاً الأمر بتطهير الثياب هنا مطلق في الصلاة وفي غيرها، وهو مطلق في النجاسات والقاذورات، وهو مطلق في الكثير والقليل، وهو مطلق في كل أنواع الثياب.
فإذا تقرر ما سبق، جاء السؤال: الأمر هنا للوجوب، وهو عام لكل الأمة، وهو مطلق تماماً، فهل يلتزم الخصم بهذا؟
لا شك أنه لن يلتزم الإطلاق، لما فيه من الحرج الشديد والمشقة البالغة، والله تعالى يقول: ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ). وسيقول بل الأمر بالتطهير خاص بالنجاسات.
فيأتي السؤال التالي: ما الدليل على تخصيصه بالنجاسة دون سائر ما يتطهر منه من القاذورات والعرق والتراب ونحوها؟ وهنا ينقطع ولا شك.
ثم لو سلمنا أن الأمر هنا خاص في النجاسات وحدها دون ما عداها، فما هي النجاسات؟ هل هي ما ذكر في قوله تعالى: ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ) وعليه فالعذرة والبول والحيض والمذي وبراز الخنزير والكلاب ونحوها، كل ذلك طاهر ليس بنجس!
وإن قال أنه نجس، طالبناه بالدليل. فإن قال أنه الطبع. قلنا: الطبائع تختلف ولا تنضبط، ثم هذا يجعل حكم الله تعالى متعلقاً بما يشتهي كل واحد لنفسه، وهذا تحكيم غير الله، ولو جاز عنده لجاز تحكيم سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من باب أولى، إذ طبعه أقوم الطبائع ونفسه أشرف الأنفس.
فلن يجد بعد ذلك محيصاً للخروج من هذا الحرج الشديد إلا القول بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففيها الجواب الكافي.
ثم مثل هذه الآية في كتاب الله تعالى كثير، ومنه:
قوله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة ) تتناول تحريم السمك الميت وإيجاب ذبحه.
وقوله تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) تحتمل قطع اليد من طرف الإصبع كما تحتمل قطع اليد من الكتف.
وقوله تعالى: ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) يشمل كل ظلم ولو صغيراً.
وقوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) مع قوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) متناقضتان تماماً.
والآيتان السابقتان مع قوله تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) متناقضتان حيث تلد المرأة قبل أربعة الأشهر.
وقوله تعالى: ( والذين في أموالهم حق معلوم ) الحق لا يعلم كم هو؟ ولا ما هو؟ ولا متى هو؟ ولا ممن هو؟ ولا كيف هو؟
وقوله تعالى: ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) لا يتناول اللاتي لسن في حجورهم.
وقوله تعالى: ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) يدل على جواز إكراههن إن لم يردن التحصن.
وقوله تعالى: ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يبيح الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها.
وقوله تعالى: ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) يدل على عدم استحباب وعدم إيجاب السعي بين الصفا والمروة.
وغير ذلك كثير جداً في كتاب الله تعالى لا يمكن أن يفهم من غير بيان السنة المطهرة.
و أنبه هنا أن ذكري كل هذه الآيات ليس استدلالاً بكل منها، فتزيد الأدلة الواردة على العشر، وهو خلاف الاتفاق، وإنما الدليل الجنس. إذ دليلي كثرة ما في القرآن مما لا يفهم من غير بيان السنة النبوية المطهرة، ولا يتم لي إثبات الكثرة التي ذكرت إلا بذكر كمٍّ من الأمثلة.